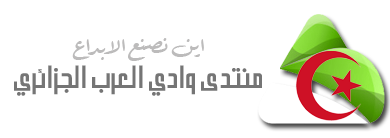يعقوب
طاقم مستشاري المنتدى
- رقم العضوية :
- 530
- البلد/ المدينة :
- زريبة الوادي
- العَمَــــــــــلْ :
- مدرسة مطالعي لتعليم السياقة
- المُسَــاهَمَـاتْ :
- 1858
- نقاط التميز :
- 2187
- التَـــسْجِيلْ :
- 07/04/2010
الأعمـــال
التجـــارية
لم تستقر التشريعات العربية التي أستمدت أغلبها
أحكامها من القانون الفرنسي بما فيها الجزائر إلى تعريف جامع مانع للعمل
التجاري كما أن القضاء عجز على ذلك مما فتح الباب أمام الفقهاء لوضع معيار
موضوعي و آخر شخصي للتمييز بين العمل التجاري و العمل المدني مما رتب على
ذلك عدة نتائج سواء من حيث الإختصاص القضائي أو قواعد الإثبات أو جزاء
الإلتزام ، وعليه سنتناول هذا الباب بالتقسيم إلى فصلين .
- فصل أول : معيار العمل التجاري و نظامه القانوني
- فصل ثاني : أنواع الأعمال التجارية
الفصل الأول : معيار العمل
التجاري و نظامه القانوني
أنقسم الفقه التجاري في
تحديده للمعيار العمل التجاري فيبينها بذهب أنصار المذهب الشخصي إلى
الإعتبارات القانونية ذهب الفريق الموضوعي ليستند إعتبارات إقتصادية ،
مرتين على ذلك عدة نتائج للتميزيين العمل التجاري و المدني .
المبحث الأول : معيار العمل
التجاري
أسند المذهب الشخصي إلى الإعتبارات القانونية
بصياغة نظرياتهم ، كنظرية السبب و نظرية الحرفة و نظرية المشروع أو
المقاولة ، أما أنصار المذهب الموضوعي فأقامو نظرياتهم على أسس إقتصادية
كنظرية المضاربة ونظرية الوساطة ونظرية التدوال .
المطلب الأول : المعايير
الموضوعية
إن المعايير الموضوعية تستند على آليات مادية في
تحديدها العمل التجاري دون مرعاة صفة القائم بهذا العمل و على هذا الأساس
فإن بعض الفقه يرى أن فكرة المضاربة هي أساس العمل التجاري في حين يذهب
البعض أن فكرة التداول هي المعيار المفضل كما يذهب فريق آخر ليقيم العمل
التجاري على أساس نظرية الوساطة إلا أن فريق آخرى يرى أن العمل التجاري
يقوم على أساس دمج فكرة نظرية التداول و المضاربة معا ، و عليه سوف تتعرض
لكلا النظرية على حدى.
1- نظرية المضاربة:
تعريفها: هي أن يسعى الشخص
من وراء العمل التجاري إلى تحقيق الربح و كسب المال أو هي توظيف رأس مال في
عمل معين بقصد الحصول على الربح من وراثة.
- هذا و قد أخد القضاء بفكرة المضاربة في كثير من أحكامه
للتمييز بين العمل المدني و العمل التجاري باعتبارها العنصر الجوهري في
العمل التجاري و بناء على ذلك فالعمل التجاري هو عمل المضاربة بالمعنى
الواسع أي قصد تحقيق الربح إلا أن فكرة المضاربة لا تعني الحصول الأكيد على
الأرباح فقد يتعرض العمل التجاري خسارة و مع ذلك يبقى العمل التجاري و
الخسارة قد تكون هدفا في حد ذاتها كما هو الحال مثلا في المزاحمة التجارية
أو المناقشة غير المشروعة ، كما أنها تكون عرضية مثل أن يشتري تاجر سلعة
لأجل بيعها دون أن يدرك أن زملائه قد أغرقوا السوق بها مما يتعرض إلى
الخسارة على أساس المخاطرة في توظيف أمواله و مع هذا فيبقى هذا العمل عملا
تجاري.
أساس هذه النظرية :
تعتبر فكرة
المضاربة أن أساس القانوني المتمثل في فكرة الشراء من آجل البيع هو السند
الذي تعتمد عليه .
غير أن هذا الأساس لا يكفي و
حده لإعتبار أن العمل تجاريا و ذلك للإنتقادات التالية :
1- أن الاخد بهذه النظرية يخرج من نطاقه القانون التجاري
للأعمال ذات الطابع الاقتصادي التي يستهدف منها الربح كما هو الشأن بالنسبة
للجمعيات التعاونيات و التي يتبع لأعضائها بسعر التكلفة.
2- أن نية الربح هو قصد وغرض معظم النشاطات البشرية فهو عنصر
مشترك بين الأعمال التجارية و المدنية متلما هو الحال عند الطبيب و
المحامي و المهندس ..................إلخ
3- أن قصد الربح أمر معنوي لا يمكن الوقوف عليه بسهولته سواء
في الأعمال المدنية أو التجارية.
4- هناك طائفة من الأعمال تهدف إلى المضاربة و مع ذلك فهي
أعمال مدنية بحثه كشراء العقارات لأجل بيعها في بعض التشريعات ( عكس المشرع
الجزائري ) وهناك أعمال لا يتوفر فيها عنصر المضاربة و مع ذلك فهي تجارية
كالسفتجة " أي الكمبيالة "
5- أن نظرية المضاربة تضع معيار إقتصاديا لا يمكن الوقوف
عنده من الناحية القانونية ، غير أن النقد غير صحيح، فلماذا يعتبر " قصد
الربح " عنصرا قانوني في فكرة الشراء لأجل البيع ، بينما يكون عنصرا
إقتصاديا إذا أتخذ كمعيار عام للعمل التجاري .
6- أن الأخذ بهذا المعيار ينفي الصفقة التجارية عن البيع
بخسارة قصد القضاء على منافس بينما نرى في الواقع أن معيار المضاربة يقوم
على نية تحقيق الربح سواء تحقق أم لا
نظرية التداول :
تعريفها : هي العمل
الذي يتعلق بالوساطة في تداول الثروات من و قت خروجها
من يد المنتج إلى وقت وصلها إلى يد المستهلك و مفاد هذه النظرية أم عملية
التداول تضفي الحركية وانتقال السلعة من المنتج إلى المستهلك كما هو في
الشراء من أجل البيع أو انتقال القيم المالية كما هو الحال في الأوراق
التجارية .
تطبيقات هذه النظرية :
- الشراء من أجل البيع : يتحقق المعيار في هذا المثل حتى و
أن لم يتحقق الربح أو لم يحصل البيع أصلا ( عدم وجود مشتري) أو حتى أن يقرر
الشخص الإحتفاظ بالسلعة لنفسه أما إذا انتفت نية البيع لدى الشخص قبل
الشراء فمعنى ذلك أنتقاء فكرة التداول فلا يعتبر العمل تجاري بل مدني .
- عمليات المناجم : تعتبر عملا تجاريا كل مقاولة لإستغلال
المناجم أو مقالع الحجارة أو منتوجات الأرض الأحرى ( المادة الثانية (م 2 ق
ت )) وذلك لأنه يتطوى على معيار التداول و بالتالي تحريك السلعة بين
المنتج إلى المستهلك ، غير أنه لا يعتبر كذلك إذا كان استخراج الثروات
للإستهلاك الشخصي .
- عمليات النقل : النقل يعطي الصورة المادية للتداول و هو
ينسجم مع العمل التجاري و حركيته و هو ما أخد به المشرع الجزائري في المادة
الثانية " كل مقاولة لأستغلال النقل و الإنتقال "
- عمليات التوسيط : السمسرة ، الوكالة بالعمولة ، وان كانت
أدوات تساعد على الحركة و انتقال القيم و الأشياء من طرف إلى أخر وعن طريق
تقريب وجهات النظر و هو ما أخد به المشرع الجزائري " كل مقاولة لإستغلال
النقل أو الإنتقال " ( م 2 . ق ت )
- تقويم النظرية :
بالرغم من أن عنصر
التداول أضفى الصيغة التجارية على عدد كبير من الأعمال التجارية كما أنه
يتلائم و يتناسب مع الحياة التجارية و يعطي الحركية و النشاط للتجارة ، غير
أن النظرية لقت انتقادات نذكر أهمها :
1- أن عنصر التداول يدخل
كذلك في النشاطات و الأعمال المدنية خاصة عند الأطباء, المهندسين, المحامين
(الخدمات , النشاطات) .
2 – إن النظربة تخرج عمل
المنتج من نطاق القانون التجاري مع العلم إن هذا الأخير هو مصدر الحركية
التجارية عن طريق التداول .
3- أن النظرية تؤدي إلى
نتائج معكوسة في بعض الأعمال التي يكون أساسها عملا مدنيا أصلا كالمزارع
الذي يزرع أرضه زهورا فهذا العمل يعتبر عملا مدنيا ، غير انه يعتبر عملا
تجاريا إذا قام بيه في باقات إلى الزبائن كذلك لشركات التنقيب فعمل التنقيب
و الأستخراج يعتبر مدنيا أما إذا بيع هذا المنتوج فيعتبر تجاريا.
نظرية التداول بقصد
المضاربة :
على ضوء عدم كفاية كلا المعيارين ( التداول و
المضاربة ) على حدى كمعيار مميز للعمل التجاري ذهب فريق من الفقهاء إلى دمج
المعيارين معا كمعيار واحد للتمييز العمل التجاري ( الأستاذين " هامل و
لجراد" )
مفهوم النظرية :
مؤدي هذه النظرية هو أن
العمل التجاري هو الذي يتوسط في تداول الثروا ت بقصد تحقيق الربح مثل
الشراء لأجل البيع فهنا العمل التجاري يقوم على أساس التوسط في تداول
الثروات كلما كان غرضه تحقيق الربح ، و هذا ما يطلق عليه أسم الأعمال
التجارية القصدية ( القانون العراقي )
تقييم النظرية :
جاءت هذه النظرية لتفادي
الإنتقادات السابقة لكلا المعيارين ( معيار المضاربة و التداول ) لكنها
تبقى غير كافية لأنها تتجاهل فكرة المشروع أو المقاولة ( معيار شخصي )
لأنها ضرورية في بعض الأعمال التجارية .
4- نظرية الوساطة :
على ضوء الإنتقادات التي
وجهت إلى نظرية المضاربة أقام الإستتئذان "ليون كان ورينو " نظرية الوساطة
كأساس جوهري للأعمال التجارية .
مفهومها: إن الصفة التجارية
تكون للأعمال القانونية التي ينتج عنها الوساطة بين المنتج و المستهلك أي
بمعنى أن الأعمال التي تكون سابقة عن عملية التوسط ( الوساطة ) و ما بعد أن
تصل السلعة إلى المستهلك تعتبر الأعمال مدينة و العبرة هنا بالأعمال
القانونية التي تجرى في مراحل الوساطة كنقل السلعة من المنتج و عمليات
السمسرة التي تقع على السلعة تم البيع ، فمثل هذه الأعمال هي التي تعتبر
تجارية دون غيرها .
و من جهة أخرى يرى أصحاب هذه
النظرية أن بعض الأعمال التجارية لا تقتضي عملية الوساطة أو جدها المشرع
لضرورة الحياة التجارية كالشيك الكيمبيالة، المكاتب الأعمال، المحل
التجاري.
تقييم النظرية : تعتبر نظرية الوساطة ، وإن كانت
تشبيه نظرية التداول ، أو سع و أرحب منها لأنها ضمت و إحتوت بعض الأعمال
التي لم تشملها نظرية التداول ، غير أن هذه النظرية هي الأخرى لا تصلح أن
تكون المعيار الوحيد للعمل التجاري لأن عمليات الوساطة التي لا تستهدف إلى
تحقيق الربح كما هو الحال في شراء بعض التعاونيات لسلعة و بيعها بسعر
التكلفة لأعضائها.
وعليه يمكن القول أن المذهب
الموضوعي قد فشل في إجاد معيار جامع مانع للعمل التجاري
المطلب الثاني: المعايير
الشخصية
يرى أصحاب هذا المذهب أنه ما دام القانون التجاري
هو قانون التجار و هو الذي ينظم مهنة التجار ، فهو قانون مهني يحكم الحرفة
التجاري و العلاقات التجارية السائدة بين التجار و لذلك يجب تحديد الحرف
التجارية لأنه لا يعيد بطبيعة العمل و لكن بالشخص القائم به ، فإذا كان هذا
الشخص غير تاجر فإن عملية يعتبر عملا مدينا و بالتالي فهو سيخضع للقانون
المدني ، أما إذا كان تاجرا فإن عمله يخضع ويطور القانون التجاري ، وفي
حقيقة هذا المذهب أنه انعكاس لاتجاه القانون التجاري نحو الشخصية الذي يسند
بعض النظريات مثل نظرية السبب و نظرية المقاولة و نظرية الحرفة .
أولا – نظرية السبب :
تعريف النظرية: لنظرية
تعريفان، قديم و حديث
- تعريف النظرية التقليدية السبب : بأنه الغرض المباشر و
المجرد الذي يريد المدين تحقيق بإلتزامه.
- أما النظرية الحديثة: فتعرف السبب بأنه " الباعث الدافع
الذي يقصد المدين تحقيقة من وراء إلتزامه
- مضمون النظرية : أن السبب الذي تقصده النظرية هو الغاية
المباشرة أو الغرض المباشر الذي يقصد ، الملتزم الوصول إليه من وراء
إلتزامه فالسبب يتميز و يختلف عن الباعث بأنه هو الغاية المباشرة و هو أول
نتيجة يصل إليها الملتزم ، أما الباعث فهو الغاية غير المباشرة فهو الأمر
الذي يريد أن يصل إليه المتعاقد من وراء تحقيق إلتزامه سواء كان الأمر
قريبا أو بعيدا مادام لا يصل إليه مباشرة من وراء إلتزامه فهو باعث لا سبب
- مثال على ذلك : أن يلتزم البائع بنقل ملكية الشئ الذي
يملكه لماذا يلتزم ؟ للحصول على الثمن لأجل شراء عقار أو التسديد ديون
تجارية ، فهنا يكون السبب هو الباعث على الإلتزام ، لذلك يسميه البعض ( سبب
العقد ) و إعتمادا على النظرية الحديثة للسبب التي أسسها الأستاذ " هنري
كابتان" و الذي يعتبر السبب هو الهدف الذي يتوخاه المتعاقدان في العقد غير
أن الأستاذ " ريقران ، REVERAND " يرى أن
السبب هو الباعث الذي يدفع كل متعاقد لتحقيق الغرض المقصود لديه.
- أساس هذه النظرية :
- أخد الأستاذ " ريقران ، REVERAND " المادة 636 من (ف ت ق ) قد أساسا تشريعا ، حيث أن المادة
جاءت بفكرة السبب تمكن في " عملية الشراء لآجل البيع " و من هنا تبين له
أن الغرض المقصود لدى المشتري هو إعادة البيع بقصد الربح و بالتالي تعد هذه
العملية و مثيلاتها من الأعمال التجارية حيث العبرة وفقا لهذه النظرية هو
القصد الذي يعتبر عنصرا جوهريا الذي يمكن من وراء المعاملات التجارية فيما
بين التجار .
- تقويم
النظرية :
على الرغم من صلاحية هذه النظرية في تفسير بعض
الأعمال التي تعتبر تجارية و بالتالي إخضاعها للقانون التجاري إلا أن هناك
من أنتقد هذه النظرية من حيث مايلي :
1- يؤخذ على هذه النظرية و أن صلحت كأساس للأعمال التجارية
القصدية فإنها عاجزة على تفسير تجارية أعمال أخرى صنفها المشرع على أنها
تجارية بغض النظر عن نية القائم بها مثل التعامل بالسفتجة .
2- صعوبة تحديد قصد القائم بالعمل إذا لم يكن تاجر أي إذا لم
يكن محترف للتجارة .
3- أن الباعث التي التعاقد أمر خفي لا يمكن الوقوف عليه أو
إدراكه سواء بالنسبة للتاجر أو غير التاجركما أن الباعث يتغير من متعاقد
إلى آخر بل أنه يزداد صعوبة إذا تعددت الدوافع لدى المتعاقد.
ثانيا – نظرية المقاولة ،
المؤسسة ، المشرع:
تعريف النظرية و نشأتها :
لم تتعرض التشريعات العربية
و منها الجزائري و لا الفرنسي تعريفا قانونيا للمقاولة أو المشروع ، وإنما
إكتفت بتحديد الأعمال التي تعتبر تجارية بنص القانون و الذي أضف صفة
التاجر على من يقوم بها .
نشأتهـــا :
أول ما نشأت هذه النظرية في
الفقه الإيطالي و تناولها الأستاذ " أوسكار " في الفقه الفرنسي عند
إنتقاده المعايير الموضوعية السابقة التي بنيت على أسس إقتصادية لا قانونية
حيث لإتجد من فكرة المقاولة معيارا للعمل التجاري إذ عرفها بأنها " تكرار
للأعمال التجارية على وجه الإحتراف بناء على تنظيم مهني مسبق " .
كما ذهب البعض إلى تعريف
المشروع بأنه كل تنظيم يكون غرضه أن يزاول الإنتاج أو تبادل السلع و
الخدمات " فالمشروع هو الوحدة الإقتصادية و القانونية التي تجمع فيها
العناصر البشرية و المادية لمزاولة النشاط الإقتصادي ".
هذا وقد إهتم المشرع
الإيطالي الصادر سنة 1942م بفكرة المشروع غير أنه لم يفرد له نظاما خاصا و
مستقبلا و مع ذلك فقد عرف المشروع عندما عرف صاحب المشروع في المادة 2082 "
بأنه كل شخص يباشر على وجد الإحتراف نشاطا إقتصاديا منظما بقصد إنتاج أو
تبادل السلع أو خدمات " كما ذهب المشرع الألماني من جهته إلى الأخد بفكرة
المشروع كمعيار للعمل التجاري و اعترف بصفة التاجر لمن يملك أو يدير مشروع
مهما كان نشاطه أو حجمه لأنه يفترض في ذلك تنظيم المؤسسة التجارية وقيدها
بالسجل التجاري إلى غير ذلك من المعايير الموضوعية .
و الجدير بالذكر أن هذا
المذهب بدأ ينتشر و يعرف تطبيقات مبدانية سواء في الصناعة أو التجارة أو
حتى في الميدان الزراعي خاصة عندما يتعلق الأمر بالإنتاج من أجل التسويق أو
حتى الوساطة بين المنتج و المستهلك التي عادة يقصد بها الربح
موضوع النظرية :
يرى أصحاب النظرية أن كيفية
ممارسة العمل القانون هي التي تميز العمل التجاري عن العمل المدني فالعمل
لا يدخل في نطاق العمل التجاري إلا إذا باشره صاحبه على وجه المقاولة أو
الإحتراف أي تكرار العمل بصفة دائمة و منتظمة.
- أن الأخد بفكرة المشروع كمعيار لثبوت صفة التاجر ، تقتضي
أن لا يكون تاجرا إلا من يشتغل مشروعا ، و يكون تنظيمه على شكل تجاري هو
الذي يحدد تبعيته و خضوعه للقانون التجاري و على هذا الأساس يتدرج القانون
التجاري من الفكر التقليدي ، كقانون خاص بالأعمال التجارية إلى قانون خاص
بالمشروعات.
- إن
الأستاذ " أوسكار " يرى بأن فكرة المشروع هو تصور إقتصادي فهو لا يكفي وحده
إلا إذا أضفينا علبة عنصر المضاربة حتى تكون بصدد مشروع إقتصادي ، حيث
يلزم الأمر إلى توافر مجموعة من العوامل القانونية و المادية لممارسة هذا
النشاط كتوظيف العمال و توفير الآلات و المعدات و تحضير مواد الإنتاج و
تجميعها في مكان خاص مع تكرار العمل ، إذا أن هناك مشروعات يعتبر عنصر
المضاربة على عمل الغير عنصرا أساسيا فيها ، مثل مشروعات الإنتاج و النقل و
البناء ، و هو ما أخد به القضاء المصري حيث أعتبر تاجرا من يضارب على عمل
الغير ، كما أن المشرع الجزائري أخد بهذا المعيار في المادة الثانية فقرة
19 متأثرا كذلك بالقضاء الفرنسي حيث أصدرت محكمة النقض بتاريخ 20 أكتوبر
1908 م حكما يقضي بأن المضاربة على عمل الغير هي روح المقاولات التي تتضمن
أعمالا مادية ، إذ جاء فيه " أن كل عملية تتضمن المضاربة المعتادة على عمل
الغير و لوكانت تنحصر في العمل دون تقديم المواد أو توريد اليد العاملة و
لا تتضمن شراء لأجل البيع أو التأجير تعتبر مشروعا صناعيا " و الحكم خاص
بمقاول لا يقدم إلا اليد العاملة .
أساس النظرية :
يستند اصحاب هذه النظرية
لتدعيم وجهة نظرهم الى :
1. ان القانون التجاري هو قانون المقاولات حيث يكون العمل
الذي يمارس على شكل مقاولة اسهل من العمل المنفرد لان المقاولة تميزها عدة
مظاهر خارجية , هذا فضلا عن دعائم القانون التجاري الأساسية وهي السرعة
والأتمانالتي تظهر اهميتها
في المقاولات دون الاعمال المنفردة .
2. ان المشرع اخد بفكرة المقاولة حيث نص على العديد منها وهو
دليل واضح على ميله و تغليبه لفكرة المقاولة على الاعمال المنفردة .
3. ان القضاء اخذ بفكرة المقاولة لاثباث تجارية العمل .
تقييم النظرية :
يرى أصحاب هذه النظرية أنها
أعطت ابعاد جديدة من حيث تطور القانون التجاري هذا فضلا على انها تتفق مع
روح التجارة اذ تتضمن معايير عديدة نادى بها الفقه كالمضاربة والتداول غير
ان هذه النظرية لم تسلم هي أيضا من الانتقاد وهو :
· ان تعريف المقاولة بأنها تكرار العمل استنادا الى التنظيم
المسبق والمادي للمهنة يعتبر تصورا اقتصاديا لا قانونيا كعنصر المضاربة
الذي أضفى الصفة التجارية على العمل التجاري.
· لا تصلح هذه النظرية
وحدها لتحديد نطاق القانون التجاري لان هناك بعض التصرفات التي تعتبر
تصرفات تجارية و لو مورست مرة واحدة .
· ان القول بان دعامة الاتمان
والسرعة لا تظهر الا في المقاولات قول مبالغ فيهلا يمكن الاخذ به على
اطلاقه فالمضارب في البورصة يكون بحاجة الى الاتمان اكثر من المقاول .
ثالثا –نظرية الحرفة :
يرى بعض الفقه الدي يتزعمه
الاستاذ جورج ريبار ان نظرية الاعمال التجارية بسبب عدم وضع معيار واحد
لتحديد هذه الاعمال كما ان العمل التجاري يستمد صفته التجارية من صفة الشخص
القائم به مثل الاعمال التجارية التبعية .
مفهوم هذه النظرية :
يعرف الاستاذ جورج ريبار
الحرفة بانها ممارسة النشاط على وجه اساسي و مستمر ومعتاد من اجل تحقيق
الربح .
الفرق بين نظرية الحرفة ونظرية المقاولة :
اذا كانت المقاولة تقوم على
المظاهر المادية كالتنظيم المادي المسبق وتجميع المواد وتوفير اليد
العاملة لتجتمع في مكان واحد فانه قد لا يتوفر ذالك في صاحب الحرفة ذالك ان
كثيرا من الحرف يقوم بها صاحبها بنفسه ولحسابه فقط .
النظام القانوني للأعمال
التجارية :
يتضح النظام القانوني للأعمال التجارية من خلال
النظام القانونية التي تحكم الأعمال التجارية و تميزها عن الأعمال المدنية و
التي ستعرض إلى أهمها:
أولا – صفة التجار :
يترتب على احتراف الأعمال
التجارية اكتساب صفة التاجر (م 1 – ف . ت . ج )فتحديد هذه الصفة القانونية
يتوقف إذن على طبيعة العمل فإذا كان العمل تجاريا فيكون القائم به تاجرا،
سواء كان فردا أم شركة.
ثانيا – الإختصاص القضائي :
تعريفه : هو الاختصاص أو
السلطة الممنوحة لجهة للفصل في القضايا المطروحة أمامها و هو إما أن يكون
نوعي أو محلي
1- الإختصاص
النوعي :ذهب المشرع الجزائري على مبدأ وحدة المحاكم المدنية و التجارية
مخالفا في ذلك المشرع الفرنسي الذي أقام المحاكم التجارية إلى جنب المحاكم
المدنية التي تعتبر هي المختصة في حل النزاع التجاري ( المادة 630 ق ن ف
)أي أن المشرع الجزائري أسند للمحكمة العادية الفصل في القضايا التجارية
إبتدائيا كما أنه خص القضايا المطروحة أمام المجالس القضائية بغرفة تجارية
تنظر المنازعات التجارية ، حيث لا يمكن إعتبارها محاكم قائمة بدأتها و أنما
يتوقف الأمر على توزيع المهام داخل المحكمة الواحدة و عليه فلا يجوز الدفع
بعدم الاختصاص إذا ما دفعت قضية تجارية أمام المحكمة العادية و القاضي هنا
يتوجب عليه إحالة القضية إلى زميله في الدائرة المختصة لنفس المحكمة أو
الحكم فيها فإن حكمه يكون صحيحا ، لأن فكرة الإختصاص النوعي ليست من النظام
العام الذي يجب عدم مخالفته كما يرى أغلب الفقهاء.
2- الإختصاص المحلي :الأصل العام أن الإختصاص في المواد
المدنية هو المحكمة التي تقع في دائرتها موطن المدعي عليه ، غير أنه في
المواد التجارية يجوز للمدعي أن يختار بين
I – محكمة موطن المدعي : إما أن يكون :
أ- الموطن الأصلي للمدعي
عليه
ب- موطن نشاطه التجاري
غير أن هناك استثناءات وردت
على هذه القاعدة و هي :
1- بالنسبة للشركات التجارية : فإن المحكمة المختصة في النظر
في المنازعات التي تكون الشركة طرفا فيها ( كمدعي عليها ) هي المحكمة التي
تكون المركز الرئيسي للشركة في دائرة إختصاصها.
2- في مواد الإفلاس أو التسوية القضائية : فإن المحكمة
المختصة هي التي يقع في دائرة إختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التسوية
القضائية.
3- في
المواد العقارية ( بيع ، إيجار ، اشغال ) : المحكمة المختصة هي التي يوجد
بدائرتها العقار
II –
محكمة الإتفاق أو إبرام العقد : و لا تكون مختصة إلا إذا كان الإتفاق حصل
كله أو بعضه إذ لا يكفي أن يتقص الطرفان على الحصول التنفيذ في دائرتها دون
أن يتحقق ذلك (9 ف إ م)
III – محكمة التنفيذ أومحل الدفع : المكان الذي تم تحديده
لتنفيذ العقد أي الوفاء فيه المادة (9 ف إ م).
ثالثا – قواعد الأثبات :
القاعدة العامة للإثبات في
المواد المدنية هي الكتابة (المادة 333 ) غير أنه في المواد التجارية فإن
للتاجر الحرية في الإثبات بكافة طرق الإثبات و مهما كانت قيمة الدين –
بالنسبة القرائن – الدفاتر التجارية و المراسلات و الفواتير
....................إلخ.
و حرية الإثبات في المواد
التجارية إمتياز يستجيب للضرورات الاقتصادية و لتدعيم مبدأ السرعة و
الائتمان التجاري غير أن لهذه القاعدة استثناءات أهمها .
1- في عقد الشركة : إذ
يشترط المشرع أن تكون الإثبات مكتوب
2- عقد شراء السفتجة أو
بيعها
3- عقد بيع المحل التجاري ورهنه
صيغة المعاملات التجارية (
الأوراق المالية ) كالشيك – الكمبيالة و الجمعيات المكتبية لا يجوز أن تكون
المكتوبة وفقا للشكل المحدد.
رابعا – جزاء الإلتزام :
I – التضامن : القاعدة العامة أن التضامن لا يفترض (لا
يوجد نص فاتورة) أما التضامن بين التجار فمقترض بين المدينين دون أن يكون
اتفاق أو نص قانوني بينما
في المعاملات المدنية يجب أن يكون هناك نص صريح أو اتفاق يقضي بذلك ، و
مبدأ إقتراض التضامن أقره العرف القضاء الفرنسي لتجنب المدين خطر الإفلاس و
لتمكين الدائن أو الدائنين من حقوقهم
II – الإفلاس :
الإفلاس نظام أوجده المشرع
التجاري بالنسبة للتجار يقابله نظام المسار بالنسبة للمعاملات المدنية
وتشرط أغالب التشريعات لتطبيق نظام الإفلاس أن يتوقف المدين على دفع ديونه
التجارية
غير أن المشرع الفرنسي و سايره في ذلك المشرع
الجزائري لا يشترط هذا الشرط و عليه فإذا توقف التاجر على دفع دين من ديونه
مدنية كانت أو تجارية فإن نظام الإفلاس هو الذي يكون جزاءا له
خامسا – الأعذار:القاعدة
العامة في المواد المدنية هو أن يقوم الدائن بإعذار المدين و مطالبته
بتنفيذ إلتزامه عند حلول أجل التنفيذ بإنذاره أو ما يقوم محل الإنذار أما
في المسائل التجارية فيمكن أن يكتفي بالمشافهة أو بخطاب عادي أو بمجر أن
بحين أجل الوفاء.
سادسا – الفـــوائد:
لا تسري الفائدة إلا بعد
الإعذار و المطالبة بها أمام القضاء في المواد المدنية أما في المسائل
التجارية فتبدأ من تاريخ الوفاء بالدين و للعلم فإن المشرع الجزائري لم
يسمح بالفائدة بين الأفراد.
أما فيما يتعلق بالفوائد
المركبة فإن المشرع التجاري يجبر تقاضي فوائد حتى و لو تجاوز مجموعها رأس
مال كما يجبر الفوائد المركبة عكس المشرع المدني أما لتعويض التكميلي الذي
يضاف إلى فوائد التاجر فإن القانون المدني يجنبه إذا يثبت أن الضرر التي
لحق بالدائن سبة تأخذ المدني في تسديد الفائدة المترتبة على الدين الأصلي
بغش منه أو بخطأ جسيم هذا بالنسبة للمعاملات المدنية أم في المعاملات
التجارية فإن حق الدائن قائم دون تكلف بإثبات الضرر
سابعا -المهلة القضائية :
حرص المشرع التجاري لتدعيم
مبدأ السرعة و الإئتمان أن يكون أجل حلول الدين هو إستحقاق الوفاء و لا
يجوز إرجاء ذلك بمهلة قضائبة كما هو الشأن في المسائل المدنية فقد يتطلب
الأمر ذلك متى كان المدين حسن النية .
ثامنا-النفاذ المعجل :
القاعدة العامة أن الأحكام
القضائية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا حان قوة الشئ المقضي فيه
غير انه في المعاملات
التجارية فإن تنفيذ الأحكام واجب بقوة القانون على أن يدفع التاجر الذي صدر
الحكم لمعلمة ( المصلحة التجارية) كفالة لتنفيذ الحكم تنفيذا معجلا.
تاسعا-الرهن الحيازي :
يمر الرهن الحيازي بعدة
إجراءات إلا أن يكون الحكم القضائي نهائي و بموجبه يستطيع الدائن تنفيذ
الرهن الحيازي على عكس المعاملات التجارية التي الرهان المشرع في المادة 33
ف ن ج فإنه يجوز للتاجر عند استحقاق الوفاء تبلغ المدين و كفيلة بذلك و
ينتظر مدة 15 يوم بعد ذلك ليشرع في بيع المنقولات بالمزاد العلني دون أن
ينتظر حكم قضائي
عاشرا -التقـــادم :
أحتلست التشريعات في تحديد
مدة التقادم المكسب بالنسبة للتصرفات المدنية و على العموم فإنها أطول مما
يكون عليه في الأعمال التجارية فإن المشرع الفرنسي فتحدد المدة بـ 30 سنة
فإن المشرع الجزائري حددها بـ 15 سنة كقاعدة عامة ، هذا بالنسبة للمعاملات
المدنية أما في التصرفات التجارية فقد حددها بـ 383 مدني و ذلك تماشيا مع
مبدأ السرعة و الإئتمان التي أن يعتبران من مقتضيات الحياة التجارية.
حادي عشر - عدم مجانية
العمل التجاري :
لا يتصور القيام بالأعمال التجارية بدون مقابل و
عليه فإن الأجر المقابل للأعمال التجارية مقترض قد يحدده القضاء عند
الإتفاق أما في المسائل المدنية فالقاعدة العامة هو مجانية العمل المدني ما
لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك.
التجـــارية
لم تستقر التشريعات العربية التي أستمدت أغلبها
أحكامها من القانون الفرنسي بما فيها الجزائر إلى تعريف جامع مانع للعمل
التجاري كما أن القضاء عجز على ذلك مما فتح الباب أمام الفقهاء لوضع معيار
موضوعي و آخر شخصي للتمييز بين العمل التجاري و العمل المدني مما رتب على
ذلك عدة نتائج سواء من حيث الإختصاص القضائي أو قواعد الإثبات أو جزاء
الإلتزام ، وعليه سنتناول هذا الباب بالتقسيم إلى فصلين .
- فصل أول : معيار العمل التجاري و نظامه القانوني
- فصل ثاني : أنواع الأعمال التجارية
الفصل الأول : معيار العمل
التجاري و نظامه القانوني
أنقسم الفقه التجاري في
تحديده للمعيار العمل التجاري فيبينها بذهب أنصار المذهب الشخصي إلى
الإعتبارات القانونية ذهب الفريق الموضوعي ليستند إعتبارات إقتصادية ،
مرتين على ذلك عدة نتائج للتميزيين العمل التجاري و المدني .
المبحث الأول : معيار العمل
التجاري
أسند المذهب الشخصي إلى الإعتبارات القانونية
بصياغة نظرياتهم ، كنظرية السبب و نظرية الحرفة و نظرية المشروع أو
المقاولة ، أما أنصار المذهب الموضوعي فأقامو نظرياتهم على أسس إقتصادية
كنظرية المضاربة ونظرية الوساطة ونظرية التدوال .
المطلب الأول : المعايير
الموضوعية
إن المعايير الموضوعية تستند على آليات مادية في
تحديدها العمل التجاري دون مرعاة صفة القائم بهذا العمل و على هذا الأساس
فإن بعض الفقه يرى أن فكرة المضاربة هي أساس العمل التجاري في حين يذهب
البعض أن فكرة التداول هي المعيار المفضل كما يذهب فريق آخر ليقيم العمل
التجاري على أساس نظرية الوساطة إلا أن فريق آخرى يرى أن العمل التجاري
يقوم على أساس دمج فكرة نظرية التداول و المضاربة معا ، و عليه سوف تتعرض
لكلا النظرية على حدى.
1- نظرية المضاربة:
تعريفها: هي أن يسعى الشخص
من وراء العمل التجاري إلى تحقيق الربح و كسب المال أو هي توظيف رأس مال في
عمل معين بقصد الحصول على الربح من وراثة.
- هذا و قد أخد القضاء بفكرة المضاربة في كثير من أحكامه
للتمييز بين العمل المدني و العمل التجاري باعتبارها العنصر الجوهري في
العمل التجاري و بناء على ذلك فالعمل التجاري هو عمل المضاربة بالمعنى
الواسع أي قصد تحقيق الربح إلا أن فكرة المضاربة لا تعني الحصول الأكيد على
الأرباح فقد يتعرض العمل التجاري خسارة و مع ذلك يبقى العمل التجاري و
الخسارة قد تكون هدفا في حد ذاتها كما هو الحال مثلا في المزاحمة التجارية
أو المناقشة غير المشروعة ، كما أنها تكون عرضية مثل أن يشتري تاجر سلعة
لأجل بيعها دون أن يدرك أن زملائه قد أغرقوا السوق بها مما يتعرض إلى
الخسارة على أساس المخاطرة في توظيف أمواله و مع هذا فيبقى هذا العمل عملا
تجاري.
أساس هذه النظرية :
تعتبر فكرة
المضاربة أن أساس القانوني المتمثل في فكرة الشراء من آجل البيع هو السند
الذي تعتمد عليه .
غير أن هذا الأساس لا يكفي و
حده لإعتبار أن العمل تجاريا و ذلك للإنتقادات التالية :
1- أن الاخد بهذه النظرية يخرج من نطاقه القانون التجاري
للأعمال ذات الطابع الاقتصادي التي يستهدف منها الربح كما هو الشأن بالنسبة
للجمعيات التعاونيات و التي يتبع لأعضائها بسعر التكلفة.
2- أن نية الربح هو قصد وغرض معظم النشاطات البشرية فهو عنصر
مشترك بين الأعمال التجارية و المدنية متلما هو الحال عند الطبيب و
المحامي و المهندس ..................إلخ
3- أن قصد الربح أمر معنوي لا يمكن الوقوف عليه بسهولته سواء
في الأعمال المدنية أو التجارية.
4- هناك طائفة من الأعمال تهدف إلى المضاربة و مع ذلك فهي
أعمال مدنية بحثه كشراء العقارات لأجل بيعها في بعض التشريعات ( عكس المشرع
الجزائري ) وهناك أعمال لا يتوفر فيها عنصر المضاربة و مع ذلك فهي تجارية
كالسفتجة " أي الكمبيالة "
5- أن نظرية المضاربة تضع معيار إقتصاديا لا يمكن الوقوف
عنده من الناحية القانونية ، غير أن النقد غير صحيح، فلماذا يعتبر " قصد
الربح " عنصرا قانوني في فكرة الشراء لأجل البيع ، بينما يكون عنصرا
إقتصاديا إذا أتخذ كمعيار عام للعمل التجاري .
6- أن الأخذ بهذا المعيار ينفي الصفقة التجارية عن البيع
بخسارة قصد القضاء على منافس بينما نرى في الواقع أن معيار المضاربة يقوم
على نية تحقيق الربح سواء تحقق أم لا
نظرية التداول :
تعريفها : هي العمل
الذي يتعلق بالوساطة في تداول الثروات من و قت خروجها
من يد المنتج إلى وقت وصلها إلى يد المستهلك و مفاد هذه النظرية أم عملية
التداول تضفي الحركية وانتقال السلعة من المنتج إلى المستهلك كما هو في
الشراء من أجل البيع أو انتقال القيم المالية كما هو الحال في الأوراق
التجارية .
تطبيقات هذه النظرية :
- الشراء من أجل البيع : يتحقق المعيار في هذا المثل حتى و
أن لم يتحقق الربح أو لم يحصل البيع أصلا ( عدم وجود مشتري) أو حتى أن يقرر
الشخص الإحتفاظ بالسلعة لنفسه أما إذا انتفت نية البيع لدى الشخص قبل
الشراء فمعنى ذلك أنتقاء فكرة التداول فلا يعتبر العمل تجاري بل مدني .
- عمليات المناجم : تعتبر عملا تجاريا كل مقاولة لإستغلال
المناجم أو مقالع الحجارة أو منتوجات الأرض الأحرى ( المادة الثانية (م 2 ق
ت )) وذلك لأنه يتطوى على معيار التداول و بالتالي تحريك السلعة بين
المنتج إلى المستهلك ، غير أنه لا يعتبر كذلك إذا كان استخراج الثروات
للإستهلاك الشخصي .
- عمليات النقل : النقل يعطي الصورة المادية للتداول و هو
ينسجم مع العمل التجاري و حركيته و هو ما أخد به المشرع الجزائري في المادة
الثانية " كل مقاولة لأستغلال النقل و الإنتقال "
- عمليات التوسيط : السمسرة ، الوكالة بالعمولة ، وان كانت
أدوات تساعد على الحركة و انتقال القيم و الأشياء من طرف إلى أخر وعن طريق
تقريب وجهات النظر و هو ما أخد به المشرع الجزائري " كل مقاولة لإستغلال
النقل أو الإنتقال " ( م 2 . ق ت )
- تقويم النظرية :
بالرغم من أن عنصر
التداول أضفى الصيغة التجارية على عدد كبير من الأعمال التجارية كما أنه
يتلائم و يتناسب مع الحياة التجارية و يعطي الحركية و النشاط للتجارة ، غير
أن النظرية لقت انتقادات نذكر أهمها :
1- أن عنصر التداول يدخل
كذلك في النشاطات و الأعمال المدنية خاصة عند الأطباء, المهندسين, المحامين
(الخدمات , النشاطات) .
2 – إن النظربة تخرج عمل
المنتج من نطاق القانون التجاري مع العلم إن هذا الأخير هو مصدر الحركية
التجارية عن طريق التداول .
3- أن النظرية تؤدي إلى
نتائج معكوسة في بعض الأعمال التي يكون أساسها عملا مدنيا أصلا كالمزارع
الذي يزرع أرضه زهورا فهذا العمل يعتبر عملا مدنيا ، غير انه يعتبر عملا
تجاريا إذا قام بيه في باقات إلى الزبائن كذلك لشركات التنقيب فعمل التنقيب
و الأستخراج يعتبر مدنيا أما إذا بيع هذا المنتوج فيعتبر تجاريا.
نظرية التداول بقصد
المضاربة :
على ضوء عدم كفاية كلا المعيارين ( التداول و
المضاربة ) على حدى كمعيار مميز للعمل التجاري ذهب فريق من الفقهاء إلى دمج
المعيارين معا كمعيار واحد للتمييز العمل التجاري ( الأستاذين " هامل و
لجراد" )
مفهوم النظرية :
مؤدي هذه النظرية هو أن
العمل التجاري هو الذي يتوسط في تداول الثروا ت بقصد تحقيق الربح مثل
الشراء لأجل البيع فهنا العمل التجاري يقوم على أساس التوسط في تداول
الثروات كلما كان غرضه تحقيق الربح ، و هذا ما يطلق عليه أسم الأعمال
التجارية القصدية ( القانون العراقي )
تقييم النظرية :
جاءت هذه النظرية لتفادي
الإنتقادات السابقة لكلا المعيارين ( معيار المضاربة و التداول ) لكنها
تبقى غير كافية لأنها تتجاهل فكرة المشروع أو المقاولة ( معيار شخصي )
لأنها ضرورية في بعض الأعمال التجارية .
4- نظرية الوساطة :
على ضوء الإنتقادات التي
وجهت إلى نظرية المضاربة أقام الإستتئذان "ليون كان ورينو " نظرية الوساطة
كأساس جوهري للأعمال التجارية .
مفهومها: إن الصفة التجارية
تكون للأعمال القانونية التي ينتج عنها الوساطة بين المنتج و المستهلك أي
بمعنى أن الأعمال التي تكون سابقة عن عملية التوسط ( الوساطة ) و ما بعد أن
تصل السلعة إلى المستهلك تعتبر الأعمال مدينة و العبرة هنا بالأعمال
القانونية التي تجرى في مراحل الوساطة كنقل السلعة من المنتج و عمليات
السمسرة التي تقع على السلعة تم البيع ، فمثل هذه الأعمال هي التي تعتبر
تجارية دون غيرها .
و من جهة أخرى يرى أصحاب هذه
النظرية أن بعض الأعمال التجارية لا تقتضي عملية الوساطة أو جدها المشرع
لضرورة الحياة التجارية كالشيك الكيمبيالة، المكاتب الأعمال، المحل
التجاري.
تقييم النظرية : تعتبر نظرية الوساطة ، وإن كانت
تشبيه نظرية التداول ، أو سع و أرحب منها لأنها ضمت و إحتوت بعض الأعمال
التي لم تشملها نظرية التداول ، غير أن هذه النظرية هي الأخرى لا تصلح أن
تكون المعيار الوحيد للعمل التجاري لأن عمليات الوساطة التي لا تستهدف إلى
تحقيق الربح كما هو الحال في شراء بعض التعاونيات لسلعة و بيعها بسعر
التكلفة لأعضائها.
وعليه يمكن القول أن المذهب
الموضوعي قد فشل في إجاد معيار جامع مانع للعمل التجاري
المطلب الثاني: المعايير
الشخصية
يرى أصحاب هذا المذهب أنه ما دام القانون التجاري
هو قانون التجار و هو الذي ينظم مهنة التجار ، فهو قانون مهني يحكم الحرفة
التجاري و العلاقات التجارية السائدة بين التجار و لذلك يجب تحديد الحرف
التجارية لأنه لا يعيد بطبيعة العمل و لكن بالشخص القائم به ، فإذا كان هذا
الشخص غير تاجر فإن عملية يعتبر عملا مدينا و بالتالي فهو سيخضع للقانون
المدني ، أما إذا كان تاجرا فإن عمله يخضع ويطور القانون التجاري ، وفي
حقيقة هذا المذهب أنه انعكاس لاتجاه القانون التجاري نحو الشخصية الذي يسند
بعض النظريات مثل نظرية السبب و نظرية المقاولة و نظرية الحرفة .
أولا – نظرية السبب :
تعريف النظرية: لنظرية
تعريفان، قديم و حديث
- تعريف النظرية التقليدية السبب : بأنه الغرض المباشر و
المجرد الذي يريد المدين تحقيق بإلتزامه.
- أما النظرية الحديثة: فتعرف السبب بأنه " الباعث الدافع
الذي يقصد المدين تحقيقة من وراء إلتزامه
- مضمون النظرية : أن السبب الذي تقصده النظرية هو الغاية
المباشرة أو الغرض المباشر الذي يقصد ، الملتزم الوصول إليه من وراء
إلتزامه فالسبب يتميز و يختلف عن الباعث بأنه هو الغاية المباشرة و هو أول
نتيجة يصل إليها الملتزم ، أما الباعث فهو الغاية غير المباشرة فهو الأمر
الذي يريد أن يصل إليه المتعاقد من وراء تحقيق إلتزامه سواء كان الأمر
قريبا أو بعيدا مادام لا يصل إليه مباشرة من وراء إلتزامه فهو باعث لا سبب
- مثال على ذلك : أن يلتزم البائع بنقل ملكية الشئ الذي
يملكه لماذا يلتزم ؟ للحصول على الثمن لأجل شراء عقار أو التسديد ديون
تجارية ، فهنا يكون السبب هو الباعث على الإلتزام ، لذلك يسميه البعض ( سبب
العقد ) و إعتمادا على النظرية الحديثة للسبب التي أسسها الأستاذ " هنري
كابتان" و الذي يعتبر السبب هو الهدف الذي يتوخاه المتعاقدان في العقد غير
أن الأستاذ " ريقران ، REVERAND " يرى أن
السبب هو الباعث الذي يدفع كل متعاقد لتحقيق الغرض المقصود لديه.
- أساس هذه النظرية :
- أخد الأستاذ " ريقران ، REVERAND " المادة 636 من (ف ت ق ) قد أساسا تشريعا ، حيث أن المادة
جاءت بفكرة السبب تمكن في " عملية الشراء لآجل البيع " و من هنا تبين له
أن الغرض المقصود لدى المشتري هو إعادة البيع بقصد الربح و بالتالي تعد هذه
العملية و مثيلاتها من الأعمال التجارية حيث العبرة وفقا لهذه النظرية هو
القصد الذي يعتبر عنصرا جوهريا الذي يمكن من وراء المعاملات التجارية فيما
بين التجار .
- تقويم
النظرية :
على الرغم من صلاحية هذه النظرية في تفسير بعض
الأعمال التي تعتبر تجارية و بالتالي إخضاعها للقانون التجاري إلا أن هناك
من أنتقد هذه النظرية من حيث مايلي :
1- يؤخذ على هذه النظرية و أن صلحت كأساس للأعمال التجارية
القصدية فإنها عاجزة على تفسير تجارية أعمال أخرى صنفها المشرع على أنها
تجارية بغض النظر عن نية القائم بها مثل التعامل بالسفتجة .
2- صعوبة تحديد قصد القائم بالعمل إذا لم يكن تاجر أي إذا لم
يكن محترف للتجارة .
3- أن الباعث التي التعاقد أمر خفي لا يمكن الوقوف عليه أو
إدراكه سواء بالنسبة للتاجر أو غير التاجركما أن الباعث يتغير من متعاقد
إلى آخر بل أنه يزداد صعوبة إذا تعددت الدوافع لدى المتعاقد.
ثانيا – نظرية المقاولة ،
المؤسسة ، المشرع:
تعريف النظرية و نشأتها :
لم تتعرض التشريعات العربية
و منها الجزائري و لا الفرنسي تعريفا قانونيا للمقاولة أو المشروع ، وإنما
إكتفت بتحديد الأعمال التي تعتبر تجارية بنص القانون و الذي أضف صفة
التاجر على من يقوم بها .
نشأتهـــا :
أول ما نشأت هذه النظرية في
الفقه الإيطالي و تناولها الأستاذ " أوسكار " في الفقه الفرنسي عند
إنتقاده المعايير الموضوعية السابقة التي بنيت على أسس إقتصادية لا قانونية
حيث لإتجد من فكرة المقاولة معيارا للعمل التجاري إذ عرفها بأنها " تكرار
للأعمال التجارية على وجه الإحتراف بناء على تنظيم مهني مسبق " .
كما ذهب البعض إلى تعريف
المشروع بأنه كل تنظيم يكون غرضه أن يزاول الإنتاج أو تبادل السلع و
الخدمات " فالمشروع هو الوحدة الإقتصادية و القانونية التي تجمع فيها
العناصر البشرية و المادية لمزاولة النشاط الإقتصادي ".
هذا وقد إهتم المشرع
الإيطالي الصادر سنة 1942م بفكرة المشروع غير أنه لم يفرد له نظاما خاصا و
مستقبلا و مع ذلك فقد عرف المشروع عندما عرف صاحب المشروع في المادة 2082 "
بأنه كل شخص يباشر على وجد الإحتراف نشاطا إقتصاديا منظما بقصد إنتاج أو
تبادل السلع أو خدمات " كما ذهب المشرع الألماني من جهته إلى الأخد بفكرة
المشروع كمعيار للعمل التجاري و اعترف بصفة التاجر لمن يملك أو يدير مشروع
مهما كان نشاطه أو حجمه لأنه يفترض في ذلك تنظيم المؤسسة التجارية وقيدها
بالسجل التجاري إلى غير ذلك من المعايير الموضوعية .
و الجدير بالذكر أن هذا
المذهب بدأ ينتشر و يعرف تطبيقات مبدانية سواء في الصناعة أو التجارة أو
حتى في الميدان الزراعي خاصة عندما يتعلق الأمر بالإنتاج من أجل التسويق أو
حتى الوساطة بين المنتج و المستهلك التي عادة يقصد بها الربح
موضوع النظرية :
يرى أصحاب النظرية أن كيفية
ممارسة العمل القانون هي التي تميز العمل التجاري عن العمل المدني فالعمل
لا يدخل في نطاق العمل التجاري إلا إذا باشره صاحبه على وجه المقاولة أو
الإحتراف أي تكرار العمل بصفة دائمة و منتظمة.
- أن الأخد بفكرة المشروع كمعيار لثبوت صفة التاجر ، تقتضي
أن لا يكون تاجرا إلا من يشتغل مشروعا ، و يكون تنظيمه على شكل تجاري هو
الذي يحدد تبعيته و خضوعه للقانون التجاري و على هذا الأساس يتدرج القانون
التجاري من الفكر التقليدي ، كقانون خاص بالأعمال التجارية إلى قانون خاص
بالمشروعات.
- إن
الأستاذ " أوسكار " يرى بأن فكرة المشروع هو تصور إقتصادي فهو لا يكفي وحده
إلا إذا أضفينا علبة عنصر المضاربة حتى تكون بصدد مشروع إقتصادي ، حيث
يلزم الأمر إلى توافر مجموعة من العوامل القانونية و المادية لممارسة هذا
النشاط كتوظيف العمال و توفير الآلات و المعدات و تحضير مواد الإنتاج و
تجميعها في مكان خاص مع تكرار العمل ، إذا أن هناك مشروعات يعتبر عنصر
المضاربة على عمل الغير عنصرا أساسيا فيها ، مثل مشروعات الإنتاج و النقل و
البناء ، و هو ما أخد به القضاء المصري حيث أعتبر تاجرا من يضارب على عمل
الغير ، كما أن المشرع الجزائري أخد بهذا المعيار في المادة الثانية فقرة
19 متأثرا كذلك بالقضاء الفرنسي حيث أصدرت محكمة النقض بتاريخ 20 أكتوبر
1908 م حكما يقضي بأن المضاربة على عمل الغير هي روح المقاولات التي تتضمن
أعمالا مادية ، إذ جاء فيه " أن كل عملية تتضمن المضاربة المعتادة على عمل
الغير و لوكانت تنحصر في العمل دون تقديم المواد أو توريد اليد العاملة و
لا تتضمن شراء لأجل البيع أو التأجير تعتبر مشروعا صناعيا " و الحكم خاص
بمقاول لا يقدم إلا اليد العاملة .
أساس النظرية :
يستند اصحاب هذه النظرية
لتدعيم وجهة نظرهم الى :
1. ان القانون التجاري هو قانون المقاولات حيث يكون العمل
الذي يمارس على شكل مقاولة اسهل من العمل المنفرد لان المقاولة تميزها عدة
مظاهر خارجية , هذا فضلا عن دعائم القانون التجاري الأساسية وهي السرعة
والأتمانالتي تظهر اهميتها
في المقاولات دون الاعمال المنفردة .
2. ان المشرع اخد بفكرة المقاولة حيث نص على العديد منها وهو
دليل واضح على ميله و تغليبه لفكرة المقاولة على الاعمال المنفردة .
3. ان القضاء اخذ بفكرة المقاولة لاثباث تجارية العمل .
تقييم النظرية :
يرى أصحاب هذه النظرية أنها
أعطت ابعاد جديدة من حيث تطور القانون التجاري هذا فضلا على انها تتفق مع
روح التجارة اذ تتضمن معايير عديدة نادى بها الفقه كالمضاربة والتداول غير
ان هذه النظرية لم تسلم هي أيضا من الانتقاد وهو :
· ان تعريف المقاولة بأنها تكرار العمل استنادا الى التنظيم
المسبق والمادي للمهنة يعتبر تصورا اقتصاديا لا قانونيا كعنصر المضاربة
الذي أضفى الصفة التجارية على العمل التجاري.
· لا تصلح هذه النظرية
وحدها لتحديد نطاق القانون التجاري لان هناك بعض التصرفات التي تعتبر
تصرفات تجارية و لو مورست مرة واحدة .
· ان القول بان دعامة الاتمان
والسرعة لا تظهر الا في المقاولات قول مبالغ فيهلا يمكن الاخذ به على
اطلاقه فالمضارب في البورصة يكون بحاجة الى الاتمان اكثر من المقاول .
ثالثا –نظرية الحرفة :
يرى بعض الفقه الدي يتزعمه
الاستاذ جورج ريبار ان نظرية الاعمال التجارية بسبب عدم وضع معيار واحد
لتحديد هذه الاعمال كما ان العمل التجاري يستمد صفته التجارية من صفة الشخص
القائم به مثل الاعمال التجارية التبعية .
مفهوم هذه النظرية :
يعرف الاستاذ جورج ريبار
الحرفة بانها ممارسة النشاط على وجه اساسي و مستمر ومعتاد من اجل تحقيق
الربح .
الفرق بين نظرية الحرفة ونظرية المقاولة :
اذا كانت المقاولة تقوم على
المظاهر المادية كالتنظيم المادي المسبق وتجميع المواد وتوفير اليد
العاملة لتجتمع في مكان واحد فانه قد لا يتوفر ذالك في صاحب الحرفة ذالك ان
كثيرا من الحرف يقوم بها صاحبها بنفسه ولحسابه فقط .
النظام القانوني للأعمال
التجارية :
يتضح النظام القانوني للأعمال التجارية من خلال
النظام القانونية التي تحكم الأعمال التجارية و تميزها عن الأعمال المدنية و
التي ستعرض إلى أهمها:
أولا – صفة التجار :
يترتب على احتراف الأعمال
التجارية اكتساب صفة التاجر (م 1 – ف . ت . ج )فتحديد هذه الصفة القانونية
يتوقف إذن على طبيعة العمل فإذا كان العمل تجاريا فيكون القائم به تاجرا،
سواء كان فردا أم شركة.
ثانيا – الإختصاص القضائي :
تعريفه : هو الاختصاص أو
السلطة الممنوحة لجهة للفصل في القضايا المطروحة أمامها و هو إما أن يكون
نوعي أو محلي
1- الإختصاص
النوعي :ذهب المشرع الجزائري على مبدأ وحدة المحاكم المدنية و التجارية
مخالفا في ذلك المشرع الفرنسي الذي أقام المحاكم التجارية إلى جنب المحاكم
المدنية التي تعتبر هي المختصة في حل النزاع التجاري ( المادة 630 ق ن ف
)أي أن المشرع الجزائري أسند للمحكمة العادية الفصل في القضايا التجارية
إبتدائيا كما أنه خص القضايا المطروحة أمام المجالس القضائية بغرفة تجارية
تنظر المنازعات التجارية ، حيث لا يمكن إعتبارها محاكم قائمة بدأتها و أنما
يتوقف الأمر على توزيع المهام داخل المحكمة الواحدة و عليه فلا يجوز الدفع
بعدم الاختصاص إذا ما دفعت قضية تجارية أمام المحكمة العادية و القاضي هنا
يتوجب عليه إحالة القضية إلى زميله في الدائرة المختصة لنفس المحكمة أو
الحكم فيها فإن حكمه يكون صحيحا ، لأن فكرة الإختصاص النوعي ليست من النظام
العام الذي يجب عدم مخالفته كما يرى أغلب الفقهاء.
2- الإختصاص المحلي :الأصل العام أن الإختصاص في المواد
المدنية هو المحكمة التي تقع في دائرتها موطن المدعي عليه ، غير أنه في
المواد التجارية يجوز للمدعي أن يختار بين
I – محكمة موطن المدعي : إما أن يكون :
أ- الموطن الأصلي للمدعي
عليه
ب- موطن نشاطه التجاري
غير أن هناك استثناءات وردت
على هذه القاعدة و هي :
1- بالنسبة للشركات التجارية : فإن المحكمة المختصة في النظر
في المنازعات التي تكون الشركة طرفا فيها ( كمدعي عليها ) هي المحكمة التي
تكون المركز الرئيسي للشركة في دائرة إختصاصها.
2- في مواد الإفلاس أو التسوية القضائية : فإن المحكمة
المختصة هي التي يقع في دائرة إختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التسوية
القضائية.
3- في
المواد العقارية ( بيع ، إيجار ، اشغال ) : المحكمة المختصة هي التي يوجد
بدائرتها العقار
II –
محكمة الإتفاق أو إبرام العقد : و لا تكون مختصة إلا إذا كان الإتفاق حصل
كله أو بعضه إذ لا يكفي أن يتقص الطرفان على الحصول التنفيذ في دائرتها دون
أن يتحقق ذلك (9 ف إ م)
III – محكمة التنفيذ أومحل الدفع : المكان الذي تم تحديده
لتنفيذ العقد أي الوفاء فيه المادة (9 ف إ م).
ثالثا – قواعد الأثبات :
القاعدة العامة للإثبات في
المواد المدنية هي الكتابة (المادة 333 ) غير أنه في المواد التجارية فإن
للتاجر الحرية في الإثبات بكافة طرق الإثبات و مهما كانت قيمة الدين –
بالنسبة القرائن – الدفاتر التجارية و المراسلات و الفواتير
....................إلخ.
و حرية الإثبات في المواد
التجارية إمتياز يستجيب للضرورات الاقتصادية و لتدعيم مبدأ السرعة و
الائتمان التجاري غير أن لهذه القاعدة استثناءات أهمها .
1- في عقد الشركة : إذ
يشترط المشرع أن تكون الإثبات مكتوب
2- عقد شراء السفتجة أو
بيعها
3- عقد بيع المحل التجاري ورهنه
صيغة المعاملات التجارية (
الأوراق المالية ) كالشيك – الكمبيالة و الجمعيات المكتبية لا يجوز أن تكون
المكتوبة وفقا للشكل المحدد.
رابعا – جزاء الإلتزام :
I – التضامن : القاعدة العامة أن التضامن لا يفترض (لا
يوجد نص فاتورة) أما التضامن بين التجار فمقترض بين المدينين دون أن يكون
اتفاق أو نص قانوني بينما
في المعاملات المدنية يجب أن يكون هناك نص صريح أو اتفاق يقضي بذلك ، و
مبدأ إقتراض التضامن أقره العرف القضاء الفرنسي لتجنب المدين خطر الإفلاس و
لتمكين الدائن أو الدائنين من حقوقهم
II – الإفلاس :
الإفلاس نظام أوجده المشرع
التجاري بالنسبة للتجار يقابله نظام المسار بالنسبة للمعاملات المدنية
وتشرط أغالب التشريعات لتطبيق نظام الإفلاس أن يتوقف المدين على دفع ديونه
التجارية
غير أن المشرع الفرنسي و سايره في ذلك المشرع
الجزائري لا يشترط هذا الشرط و عليه فإذا توقف التاجر على دفع دين من ديونه
مدنية كانت أو تجارية فإن نظام الإفلاس هو الذي يكون جزاءا له
خامسا – الأعذار:القاعدة
العامة في المواد المدنية هو أن يقوم الدائن بإعذار المدين و مطالبته
بتنفيذ إلتزامه عند حلول أجل التنفيذ بإنذاره أو ما يقوم محل الإنذار أما
في المسائل التجارية فيمكن أن يكتفي بالمشافهة أو بخطاب عادي أو بمجر أن
بحين أجل الوفاء.
سادسا – الفـــوائد:
لا تسري الفائدة إلا بعد
الإعذار و المطالبة بها أمام القضاء في المواد المدنية أما في المسائل
التجارية فتبدأ من تاريخ الوفاء بالدين و للعلم فإن المشرع الجزائري لم
يسمح بالفائدة بين الأفراد.
أما فيما يتعلق بالفوائد
المركبة فإن المشرع التجاري يجبر تقاضي فوائد حتى و لو تجاوز مجموعها رأس
مال كما يجبر الفوائد المركبة عكس المشرع المدني أما لتعويض التكميلي الذي
يضاف إلى فوائد التاجر فإن القانون المدني يجنبه إذا يثبت أن الضرر التي
لحق بالدائن سبة تأخذ المدني في تسديد الفائدة المترتبة على الدين الأصلي
بغش منه أو بخطأ جسيم هذا بالنسبة للمعاملات المدنية أم في المعاملات
التجارية فإن حق الدائن قائم دون تكلف بإثبات الضرر
سابعا -المهلة القضائية :
حرص المشرع التجاري لتدعيم
مبدأ السرعة و الإئتمان أن يكون أجل حلول الدين هو إستحقاق الوفاء و لا
يجوز إرجاء ذلك بمهلة قضائبة كما هو الشأن في المسائل المدنية فقد يتطلب
الأمر ذلك متى كان المدين حسن النية .
ثامنا-النفاذ المعجل :
القاعدة العامة أن الأحكام
القضائية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا حان قوة الشئ المقضي فيه
غير انه في المعاملات
التجارية فإن تنفيذ الأحكام واجب بقوة القانون على أن يدفع التاجر الذي صدر
الحكم لمعلمة ( المصلحة التجارية) كفالة لتنفيذ الحكم تنفيذا معجلا.
تاسعا-الرهن الحيازي :
يمر الرهن الحيازي بعدة
إجراءات إلا أن يكون الحكم القضائي نهائي و بموجبه يستطيع الدائن تنفيذ
الرهن الحيازي على عكس المعاملات التجارية التي الرهان المشرع في المادة 33
ف ن ج فإنه يجوز للتاجر عند استحقاق الوفاء تبلغ المدين و كفيلة بذلك و
ينتظر مدة 15 يوم بعد ذلك ليشرع في بيع المنقولات بالمزاد العلني دون أن
ينتظر حكم قضائي
عاشرا -التقـــادم :
أحتلست التشريعات في تحديد
مدة التقادم المكسب بالنسبة للتصرفات المدنية و على العموم فإنها أطول مما
يكون عليه في الأعمال التجارية فإن المشرع الفرنسي فتحدد المدة بـ 30 سنة
فإن المشرع الجزائري حددها بـ 15 سنة كقاعدة عامة ، هذا بالنسبة للمعاملات
المدنية أما في التصرفات التجارية فقد حددها بـ 383 مدني و ذلك تماشيا مع
مبدأ السرعة و الإئتمان التي أن يعتبران من مقتضيات الحياة التجارية.
حادي عشر - عدم مجانية
العمل التجاري :
لا يتصور القيام بالأعمال التجارية بدون مقابل و
عليه فإن الأجر المقابل للأعمال التجارية مقترض قد يحدده القضاء عند
الإتفاق أما في المسائل المدنية فالقاعدة العامة هو مجانية العمل المدني ما
لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك.